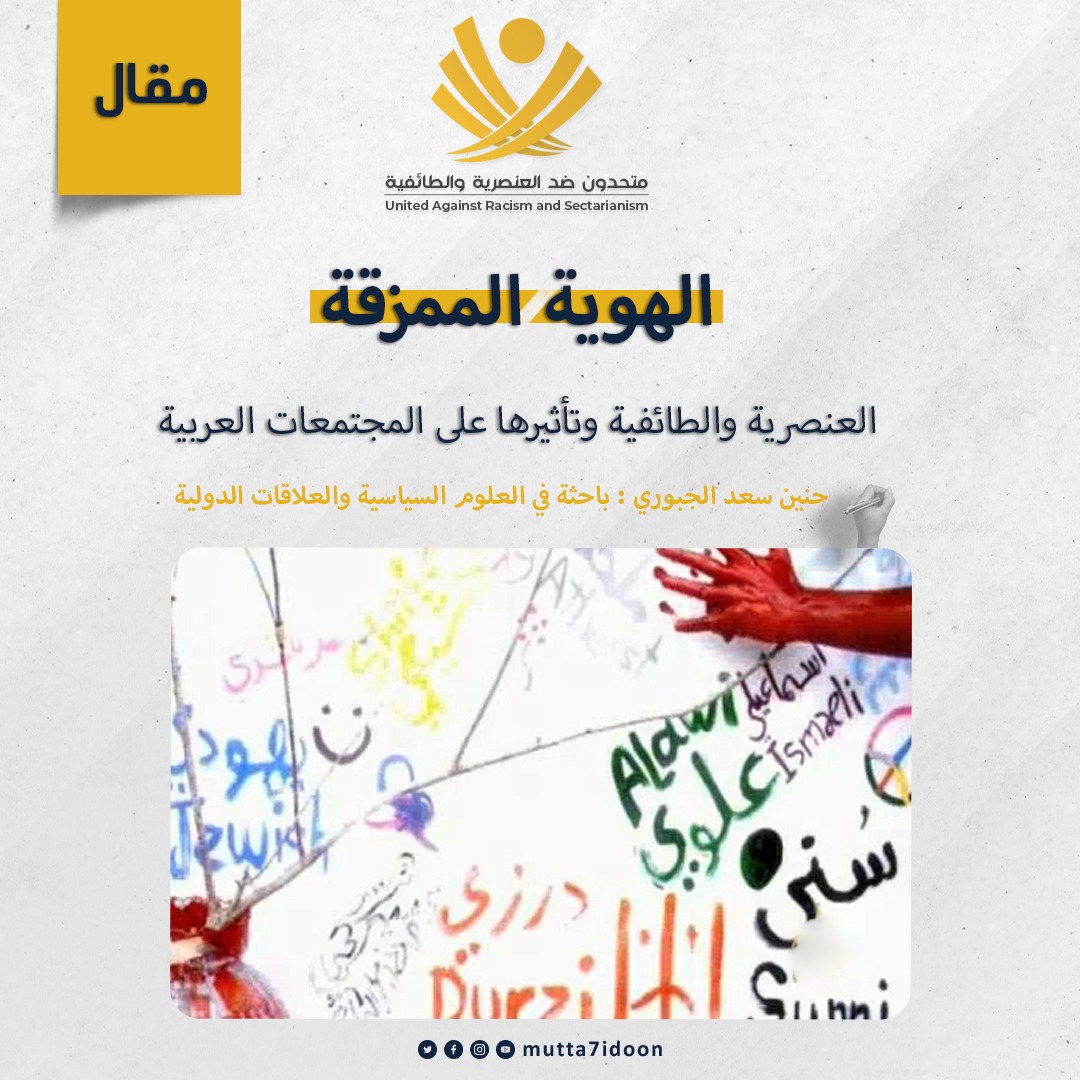حنين سعد الجبوري : باحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
المقدمة:
يقول تعالى في محكم تنزيله ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ﴾[1]. وفي هذه الآية أدلة عقلية نبه الله العقول إليها لنتفكر لاحتوائها على العبر لكل ذي علم وبصيرة. إذ لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى ، ولكن في وقتنا الحاضر أصبحت العنصرية والطائفية أشبه بالقنابل الموقوتة؛ تهدد أمن المجتمع واستقراره وتعمل على تفكيك مكوناته مما يخلق نسفاً للقيم وخراباً للأوطان والشعوب. إذ تعد العنصرية والطائفية من أخطر الظواهر الاجتماعية والسياسية التي تهدد تماسك المجتمعات، وتُضعف من بُنيتها الوطنية. فالعنصرية هي التمييز القائم على اللون والعرق والأصل القومي، أما الطائفية فهي قائمة على الانحياز لطائفة معينة دون الطوائف الأخرى أو العداء على أساس الانتماء الديني. وهذه الظاهرة ليست جديدة على المجتمعات العربية ، خصوصاً وأن تجذرها أصبح أكثر حدة في العقود الأخيرة. هذه الظاهرة بدأت تتشكل مع تدخل القوى الخارجية وغياب مؤسسات الدولة الوطنية مما جعلها تحتد وتصل ذروتها إلى نزاعات داخلية.
الأحداث التي ظهرت في السنين الاخيرة في العراق وسوريا ولبنان وحتى اليمن، أظهرت أن الطائفية لم تعد مجرد خلاف مذهبي؛ بل تحولت إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، و أصبحت العنصرية تغذي اوجهاً متعددة من التمييز الطبقي والثقافي، بالإضافة إلى الأقليات الإثنية والموقف من اللاجئين في بعض الدول.[2] حيث تؤدي العنصرية والطائفية إلى انقسامات تعمل على تفتيت الهوية الجامعة وتعرقل مسارات التنمية والاستقرار والديمقراطية . ومن هنا تبرز لنا أهمية تحليل تداعيات العنصرية والطائفية على أمن الدول وهويتها ومستقبلها، والسعي لاقتراح بدائل فكرية و مؤسسية قادرة على تجاوزها.
الجذور التاريخية والاجتماعية للطائفية والعنصرية
العنصرية والطائفية هي ظواهر تشكلت نتيجة الممارسات السياسية والاجتماعية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. حيث برزت أولى علامات الطائفية في الدول العربية في عصر النهضة و الاصلاحات العثمانية؛ والتي تعتبر طائفية سياسية، لأنها تعود بالنفع للمصالح السياسية في المنطقة. حيث بدأت تستخدم الدين كأداة للتمييز في مواجهة مفهوم المواطنة المتحررة. [3]وفي هذا السياق؛ عملت القوى الاستعمارية الغربية مثل بريطانيا وفرنسا على تقسيم الدول العربية على أسس طائفية واثنية؛ مثل إتفاقية سايكس بيكو عام 1916 التي قسمت العراق وسوريا ولبنان وزرعت بذور الانقسامات الطائفية والإثنية؛ وذلك لضمان النفوذ الغربي وتمركزه في المنطقة.[4] بالعودة إلى التاريخ نرى أن لبنان قد ظهرت فيها الطائفية السياسية في مرحلة تأسيس لبنان الكبير عام 1920 من أجل تقسيم لبنان على أساس ديني، وهذا أدى إلى إعتماد المحاصصة الطائفية لاحقاً.[5] كما أن هذا التحول كان نتيجة لتدخل القوى الأوربية التي كانت تنتهج سياسة تفتيت الكيان الوطني من خلال تعزيز الانتماءات الدينية. وبعد الثورة الإيرانية عام 1979 وصعود الجمهورية الإيرانية إلى سدة الحكم لعبت دوراً مهماً في تحويل الانقسامات الداخلية إلى نفوذ إقليمي. أما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 فقد لعبت التدخلات الخارجية دوراً في صعود خطاب طائفي وإنتاج بيئات طائفية مستمرة .[6] أما العنصرية فقد ظهرت بمعانٍ موازية ولكنها اقتصرت على تمييز عرقي أو ثقافي في بعض الدول العربية مستفيدة من الانقسامات
[1] سورة الروم ، الآية 22.
[2] فارع المسلمي ، ” الطائفية بين السنة والشيعة تدس السم في اليمن “، مركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط ، 2015\12\29، https://is.gd/XiJLMr
[3] أسامة مقدسي، ” انقسامات داخلية وانقسامات خارجية “، مجلة برلين ، https://is.gd/E8yfVz
[4] الجزيرة نت ،” سايكس بيكو… يوم قسمت فرنسا وبريطانيا تركة العثمانيين بينهما” ،2024\4\13، https://is.gd/aacPBl
[5] أسامة مقدسي، ” انقسامات داخلية وانقسامات خارجية “، مجلة برلين ، https://is.gd/E8yfVz
[6] مروان قبلان ،”الطائفية في الشرق الاوسط : أعراض لسبب”، المركز العربي واشنطن دي سي، 2019\6\1، https://is.gd/N4ywcH
واللغوية داخل الدولة. والخلاصة أن الطائفية والعنصرية هي أدوات سياسية تم استخدامها للسيطرة على الدولة أو تحييدها بسبب التدخلات الدولية والإقليمية؛ ونتيجةً لذلك أصبح الانتماء الوطني هشاً بسبب الطائفية التي استغلت لخدمة أجندات سياسية.
الطائفية والعنصرية وتأثيرها على تماسك الدولة الوطنية
ساهمت الطائفية والعنصرية في العالم العربي في تفكيك الهوية الوطنية الجامعة ؛ وهذا ما يظهر جلياً وبكل وضوح في بعض الدول التي انزلقت نحو صراعات بعد انهيار الأنظمة المركزية، مثل العراق وسوريا واليمن .والعراق هو أحد الأمثلة البارزة على إنهيار الدولة بسبب الطائفية؛ فقد أدى انهيار الدولة المركزية في العراق عام 2003 إلى تفكك الهوية الوطنية الجامعة لحساب الهويات الطائفية الإثنية ، واصبح الولاء للطائفة أو القومية يتقدم على الولاء للدولة، وبحسب تقرير صادر عن مركز كارنيغي أن اعتماد نظام المحاصصة بعد عام 2005 زاد من هذا التفكك وترسيخ الانقسامات، مما أدى إلى صراعات داخلية، وانتج ما يسمى بـ”دولة الهويات المتعددة”.[1] ويبرز هنا أن للطائفية والعنصرية دور وتأثير مباشر على تفكيك النسيج الوطني، حيث تصبح الدولة ساحة لنزع الهويات مما يجعلها تفتقر إلى ولاء جامع والذي يساهم في فتح الباب أمام النزاعات الداخلية والإقليمية والدولية تحت ذرائع حماية بعض المكونات. البيئة العراقية الحالية هي نموذجاً لتفكك الهوية الوطنية، بسبب الطائفية؛ والنتيجة هي تتمحور حول مدى خطورة الطائفية على تماسك الدولة ليس فقط على البناء السياسي؛ بل يؤثر على عمق النسيج الاجتماعي. كما أن هذا النموذج يتكرر بصيغ مختلفة في دول عربية أخرى مثل سوريا ولبنان والسودان واليمن. حيث أدت الانقسامات الطائفية إلى حروب داخلية وتهجير واسع، فضلا عن تداعيات اقتصادية دمرت البنية التحتية والتنمية. في عام 2011 اندلعت الثورة السورية وسرعان ما تحولت الثورة إلى صراع مسلح والذي أخذ طابعاً طائفياً. حيث لعب النظام السوري السابق دوراً محورياً في تأجيج البعد الطائفي إلى صراع، وذلك من خلال تصوير الحراك الشعبي كتهديد “سني” ضد الأقليات، وعلى وجه الخصوص الطائفة العلوية. وساهمت هذه الخطوة في تعميق الانقسام وتحويل الثورة إلى حرب أهلية شاملة. النظام السابق للجمهورية السورية ساهم في تأجيج الطائفية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن التهجير القسري الذي شهدته البلاد أنذاك دفع الشعب السوري إلى براثن الفقر المدقع. وهذا أدى إلى نزوح ملايين اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة مما فرض ضغطاً هائلاً على الدول المستضيفة كـ تركيا والعراق والأردن ومصر .[2] الطائفية والعنصرية لا تؤدي فقط إلى تهجير ودمار بشري أو خلافات على المناصب؛ بل تحمل كلفة اقتصادية فادحة. إذ تنهار بيئة الاستثمار وتُهرب رؤوس الأموال، وتراجع في التعليم وغياب العدالة الاجتماعية. من خلال ما سبق تُظهر التجارب العربية أن الاستمرار في تجاهل هذه الظواهر يؤدي إلى مفاقمة الأزمات؛ ويجب على الحكومات إعادة النظر وبناء عقد اجتماعي جديد قائم على المواطنة لا الطائفة والعرق.
كيف تعزز الطائفية والعنصرية ثقافة الكراهية
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصات مفتوحة لنشر خطاب الكراهية الطائفي والعنصري، حيث غابت الرقابة وكثرت الحسابات الوهمية وتحولت هذه الوسائل إلى ساحات مفتوحة لتبادل الشتائم الطائفية، لا سيما في أوقات الأزمات والانتخابات، كما في العراق وسوريا ولبنان. إضافة إلى ذلك تستغل بعض الجماعات المتطرفة هذه المنصات من أجل تأجيج النزعات الهوياتية. علاوة على ذلك أن بعض القنوات العربية لعبت دوراً سلبياً في تعزيز هذه الانقسامات من خلال تبني اجندات طائفية أو تتحدث عن وجود مكونات سكانية على أنها تهديد وجودي.[3] إذن الطائفية والعنصرية هي أكثر خطورة عندما تتسلل إلى أدوات التشكيل الجمعي للرأي العام، كوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وهنا لا تقتصر على أنها مواقف عابرة، بل تصبح نمطاً مؤسساتياً في إنتاج الكراهية والانقسامات. إذ لم تواجه منصات التواصل الاجتماعي والإعلام بمنظومة قانونية وتربوية وإعلامية حازمة فإنه العالم العربي سيبقى رهينة لصراع الهويات.
[1] فنار حداد،”الطائفية في العراق : رؤى متعارضة للوحدة”، “مجلة العلاقات الدولية، المجلس الدولي للعلاقات التركية”، المجلد 15، العدد 59، 2018، https://is.gd/rEhdhN
[2] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “ماذا يحدث في سوريا والدول المجاورة؟” ، 2024، https://is.gd/UaYYyS
[3] حسين اليوسفي المغاري،”عن خطاب الكراهية في وسائل الاعلام”، الجزيرة، 2027\4\13، https://is.gd/yRX6rG
معالجة الطائفية والعنصرية
من أجل مواجهة الطائفية والعنصرية وما تسببه من أزمات وتفكك اجتماعي، تبرز هنا الحاجة إلى بدائل فكرية ومجتمعية قادرة على تعزيز الهوية الجامعة. وأول ما يتصدر من هذه البدائل هو التعليم؛ لما له من أهمية وتأثير كبير في بناء الوعي الجمعي ويعتبر من أهم أدواته، ويتم ذلك من خلال مناهج تؤكد على قيم المواطنة والتعددية وحقوق الإنسان بعيداً عن الهويات الفرعية أو الانغلاق. كما يمكن ايضا في المناهج الدراسية تضمين تاريخ مشترك غير متحيز إلى طائفة أو عرق معين، بالإضافة إلى الابتعاد عن الخطابات التحريضية. هذا سيساعد على ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادلة بين مكونات المجتمع. علاوة على ذلك يمكننا إلى جانب التعليم عمل برامج التوعية والحملات الحقوقية والمبادرات الشبابية العابرة للطوائف، وهذا سيعمل على تشجيع الحوار بين جميع المكونات المختلفة. كما أن هناك نماذج ملهمة عبر التاريخ في كيفية إعادة بناء المجتمع على أسس العدالة الانتقالية والمصالحة، على سبيل المثال؛ في جنوب افريقيا شكلت لجنة “الحقيقة والمصالحة” اساسا لاعتراف الضحايا والجلادين،[1] فيما اختارت راوند العدالة المجتمعية كوسيلة لحل الصراعات الأهلية وبناء الثقة.[2] من خلال هذه النماذج يظهر لنا أن معالجة آثار الطائفية والعنصرية ممكنة، ولكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإصلاح تربوي شامل، وحيز مدني يعمل على تعزيز ثقافة المواطنة والتضامن.
الخاتمة
لو استعرضنا التاريخ لجذور الطائفية والعنصرية في الأمة العربية لوجدنا أن لها آثار مدمرة لتماسك الدولة والمجتمع. وهذا يمنحنا قناعة راسخة بأن الاستمرار في تغذية الطائفية والعنصرية بأنه لا ينتج سوى المزيد من العنف والشلل المؤسساتي والانهيار الاقتصادي والاجتماعي. إن تجاوز الانتماءات الضيقة للطائفة او العرق او المنطقة أصبح ضرورة وجودية لاعادة بناء الدولة الوطنية. وذلك لأن المواطنة تضمن المساواة في الحقوق والواجبات، كما أنها تؤسس لعقد اجتماعي جديد يعيد الاعتبار للدولة كمظلة لجميع مكوناتها دون تمييز. ولأجل بناء هذا العقد الجديد يتطلب مراجعة جذرية للمنظومات التعليمية والإعلامية والسياسية، وتفعيل أدوار المجتمع المدني ومنابر الحوار المفتوح، بما يسمح بتحقيق مصالحة تاريخية داخل مجتمعاتنا، تضع حداً لثقافة الكراهية وتفتح الباب لبناء مستقبل مشترك يقوم على العدالة والكرامة.
[1] رمضان احمد بريمة،”حسن إدارة التنوع والبناء الوطني .. جنوب افريقيا إنموذجا”، الجزيرة، 2017\12\29، https://is.gd/MglUIP
[2] تيار المستقبل السوري،”دور الفضيلة في بناء الشعوب بعد الحرب الأهلية والدمار : دراسة موثقة”، 2025\3\8، https://is.gd/7tkbjT