شواهد الإثبات العنصرية
حسام شاكر
لا تستغني النزعات العنصرية وحمّى الكراهية عن “شواهد إثبات” تدعم بها سرديّاتها المناهضة لمُكوِّنات محدِّدة في المجتمع أو لفئات معيّنة من البشر.
تجد هذه النزعات ضالّتها في تجاوزات يرتكبها أفراد محسوبون على مَن تذمّهم وتُحرِّض ضدّهم؛ على نحو تبتغي منه تبرير منطقها وتأكيد
حجّتها وتعزيز أحكامها.
وإذ تقوم السرديّات العنصرية والتمييزية والتحريضية والمُتحاملة على وَصْم مُكوِّنات أو فئات معيّنة بنزعات إجرامية، مثلاً، فإنّها لن تتردّد في اقتناص
أيِّ جرائم يقترفها محسوبون على تلك المُكوِّنات أو الفئات، فتباشر تسليط الأضواء عليها وتضخيمها في الوعي الجماهيري واستعمالها كشواهد إثبات
على صحّة منطقها وصواب أحكامها. تُستعمل هذه الوقائع أو المزاعم، المتعلِّقة بأفراد غالباً، على نحو يُراد منه إسباغ الجُرم وتعميم الاتهام على
المُكوِّنات أو الفئات التي يُحسَب هؤلاء الجناة المُفترَضون عليها.
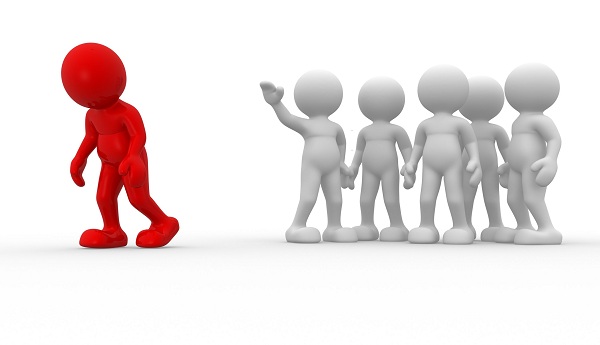
قد يجد الجمهور، بالتالي، صعوبة في مقاومة إغراء هذه السرديّات عندما تستحضر “شواهد إثبات جلِّيّة”، فهي تبدو “براهين ساطعة”
على ما حذّرت منصّات العنصرية والكراهية والتعصُّب منه مُسبقاً. من شأن هذه الحالة أن تُلجِم مناهضين للعنصرية والتمييز والتحريض
والتحامُل بسطوة الانجراف الجماهيري خلف نزعات مُغالِية، وقد يبلغ الأمر ببعض أولئك حدّ الشكّ في صحّة موقفهم المبدئي الذي كانوا عليه مع
تعاقُب “شواهد الإثبات المُحرِجة” و”البراهين” المتأخِّرة إيّاها وهيمنتها على وجدانهم وأذهانهم. وقد يتوارى بعض الحكماء خجلاً من حكمتهم
أو يُخفضون أصواتهم بدل النهوض بمسؤولية الموْقف وأمانة الكلمة وإظهار الشجاعة اللازمة لكسر جدار الصمْت الذي تواطأ غيرهم على تشييده.
تتفاقم الحالة عندما تتوفّر ما تبدو “شواهد إثبات” نموذجية، من قبيل جريمة مروِّعة يقترفها أحدهم، وقد تتكرّر جرائم معيّنة منسوبة إلى أفراد من المُكوِّنات أو الفئات عينها، فتتكرّس الوصمة التعميمية وتتضاءل فرص التعقّل في قراءة هذه الوقائع على نحو مُنصِف أو بصفة تُكافئ ما يجري مع جرائم يقترفها آخرون. هذا ما يحدث عندما تقع جريمة اغتصاب بشعة بحقّ طفلة، مثلاً، تنتهي بقتلها ثمّ العثور على جثّتها في غابة أو قبْو بعد انشغال الجمهور بمساعي البحث عنها ثم اكتشاف هوية الجاني وخلفيّته الإثنية. فما إن ينكشف ضلوع أحدهم، من المُكوِّن المعني أو الفئة المُحدّدة، بهذه الجريمة البشعة؛ حتى تنفلت المشاعر من عِقالها لتمسّ عموم هذا المُكوِّن أو الفئة بصفة صريحة أو إيحائية. إنّها اللحظة المثالية التي تتحيّنها السرديّات العنصرية والتمييزية والتحريضية والمُتحاملة كي تباشر هوايتها في تأجيج الموقف الحسّاس والنفخ في نار الأحقاد.
لا تتورّع النزعات العنصرية وحمّى الكراهية عن مسلك تعميم الاتهام وإسباغ الإدانة عندما يتّضح أنّ مقترف فِعلة معيّنة مِن المحسوبين على مُكوِّنات أو فئات موضوعة في بؤرة الاستهداف والتحامُل، فتُحَمّل تلك المُكوِّنات أو الفئات، عموماً، مسؤوليةً ما عن هذه الفِعلة بصفة واضحة أو رمزية. وقد تتورّط تغطيات إعلامية في خدمة هذه الحبكة عندما تنهمك في تسليط الأضواء على المناطق والأحياء السكنية والأوساط المجتمعية التي ينحدر منها الفاعل المُفترَض،
أو على خصوصيّته الدينية والثقافية، على نحو يُغوي بتوسيع نطاق الاشتباه ومدى المسؤولية ورمْي هذه الأنساق المجتمعية والثقافية بالضلوع الرمزي في اقتراف الفِعلة. وقد تلجأ ردود الفعل التصعيدية إلى الإدانة الجاهزة بحقّ الفرد إيّاه بصفة متسرِّعة ابتداءً؛ لا تستوفي معايير العدالة الجنائية مع المُتّهمين،
وقد تنهض هذه الإدانة على قوالب نمطية وأحكام مُسبقة أو حتى على مزاعم ينكشف زيْفها مِن بعد.
على أنّ وفرة “شواهد إثبات” على هذا النحو لا يشي في الواقع بصحّة تلك السرديّات ولا بسلامة موقفها ابتداءً أو انتهاءً. ذلك أنّ استساغة إصدار أحكام تعميمية على مُكوِّنات مجتمعية أو فئات معيّنة من البشر على أساس وقائع فردية كهذه، وإن كَثُرت أحياناً، قابل لأنْ يرتدّ على الوسط المجتمعي بالأحرى
أو على أيِّ مكوِّنات أو فئات أخرى بمجرّد تورُّط أفراد من عموم المجتمع، في الحاضر أو الماضي، في جرائم وانتهاكات وتجاوزات لا يفتقر بعضها إلى البشاعة. فالحبكة التي تلجأ إليها هذه السرديّات تقوم على تسليط الأنظار على وقائع مُحدّدة دون غيرها، وعلى مباشرة ربطها بالمُكوِّنات أو الفئات التي يُحسَب مقترفو هذه الأعمال عليها، بينما لا يُمارَس هذا التعميم مع مرتكبي أعمال شبيهة عندما ينحدرون من مجتمع الأغلبية أو مِن مكوِّنات أو فئات أخرى
لا تشملها الوصمة. فغالباً ما يُفسّر الانحراف والإجرام من خلال النطاق الشخصي للفرد إن كان من مجتمع الأغلبية أو من فئات أخرى غير مشمولة بالاستهداف، كأن يُشار إلى متاعبه النفسية أو معاناته الوظيفية أو إحباطاته الاجتماعية مثلاً؛ بينما تُحجَب هذه البواعث عن شخص مماثل لمجرّد أنّه محسوب على مكوِّن معيّن أو فئة مُحدّدة. تلك إذن قسمة ضيزى؛ فهي تُعطِّل منطقها في استصدار الأحكام عندما يرتدّ على أصحابه، لأنّه سيفتك
بسرديّات العنصرية والتمييز والتحريض والتحامُل ببساطة.
ثمّ إنّ هذه السرديّات إذ تحتفي بما تعدّه “شواهد إثبات”؛ فإنّها تتمسّك بقراءتها الأحادية المُتحيِّزة التي تبتغي منها استغلال هذه الوقائع حسب أهوائها ووفق مراميها. يأتي من ذلك، مثلاً، استحضار السِّمة الإثنية بشأن مقترفي بعض الأعمال واستبعاد سِمات أخرى لأنها لا تنسجم مع هذه السرديّات.
فإن تبيّن أنّ نسبة مقترفي جرائم معيّنة تزيد ضمن طبقات أقلّ حظوة في المجتمع، لأسباب موضوعية تتعلّق بشحّ الموارد ومواصفات السكن ومستوى التعليم وفرص الصعود الاجتماعي؛ وأنّ نسبة مكوِّنات وفئات معيّنة ضمن هذه الطبقات يُتوقّع أن تكون أعلى من غيرها؛ فهل يكون من الإنصاف ربط سلوك معيّن بالخلفية الإثنية مع إغفال الانتماء الطبقي أو التموضع الاقتصادي – الاجتماعي أو غيره من السِّمات؟!
تتجلّى هذه الحالة لدى سرديّات عنصرية ومتحاملة ذات منحى مُعولَم تذهب إلى ربط دين معيّن أو ثقافة مُحدّدة بالعنف والإرهاب، وتحتجّ في هذا المسعى بنشاط منظّمات أو بتنفيذ اعتداءات تحت شعارات تنتسب إلى هذا الدِّين أو الثقافة. من شأن الانجراف خلف هذه السرديّات أن يُعمي الأنظار عن اتجاهات ومنظّمات وحتى عن دول ضالعة في العُنف والإرهاب وتتذرّع بانتماءات دينية وثقافية مُتعدِّدة في عالمنا. فما مِن دين أو ثقافة أو أيديولوجيا إلاّ ووجدت، في الحاضر أو الماضي، مَن يرفعون شعارات تتذرّع بها وينطلقون من تأويلات معيّنة لها لتسويغ الإقدام على العنف والإرهاب وشنّ الحروب والاعتداءات. هكذا تباشر تلك السرديّات تشغيل منطقها على نحو انتقائي مدفوع بالتحيُّز الذي يتحاشى الاعتراف بالواقع على ما هو عليه.
ثمّ إنّ حيلة التعميم التي تلجأ إليها النزعات العنصرية وحمّى الكراهية تتعطّل تماماً عندما يتعلّق الأمر بإنجازات مشهودة يُحرزها أفراد محسوبون على تلك المُكوِّنات والفئات عيْنها. فالسرديّات العنصرية والتمييزية والتحريضية والمُتحاملة تميل إلى تقديم القاتل والسارق والمُعتدي بصفة ممثِّلين حصريِّين لهذه المُكوِّنات والفئات؛ وتُصِرّ في الوقت ذاته على تجاهُل أوساط منها قدّمت خدمات جليلة للمجتمع والبلد والإنسانية في حقول شتّى، أو حقّقت نجاحات علمية وعملية ومهنية في مجالات مُتعدِّدة، كما تتغافل عن أوساط عريضة اختارت العيش بسلام ووئام وانضباط بالأنظمة المعمول بها في هذه البيئات.
ومن مُفارقات هذه الحبكة أنّها إذ تحرص على وَصْم مُكوِّنات وفئات معيّنة بالجريمة والعنف والاعتداء والتجاوز؛ فإنّها تُحرِّض بعض العنصريين والمتعصِّبين على اقتراف جرائم وأعمال عنف واعتداء وترويع، والإقدام على تجاوزات متعدِّدة بحقّ هذه المكوِّنات والفئات. لا عجب أنّ بعض المُشبّعين بدعاية “الخطر الداهم” على المجتمع والهُويّة والثقافة والبلد، الذي يُلصَق بهذه المكوِّنات والفئات؛ يندفعون من تلقائهم إلى ارتكاب جرائم فائقة الخطورة بحقّ الأرواح والممتلكات والسِّلْم الأهلي، ثم لا تُعدّ هذه الأفعال الجسيمة “شواهد إثبات” أو “براهين ساطعة” على انحراف النزعات وتعصّب السرديّات؛ كما لا يُحمّل مجتمع الأغلبية جريرتها إنْ انتَسبوا إليه. وقد لا يلحظ القوم أنّ النزعات العنصرية وحمّى الكراهية هي التي تُشكِّل، بالأحرى، خطراً داهماً على المجتمع والهُويّة والثقافة والبلد وعلى الإنسانية عموماً.
غاية القول أنّ “شواهد الإثبات” و”البراهين الجلِّيّة” التي تحاول السرديّات العنصرية والتمييزية والتحريضية والمتحاملة الاستقواء بها؛ إنّما هي زيادة في التضليل، وهي تتطلّب يقظةً فائقة في التعامل معها والتصدِّي لها وتفكيك منطقها وبيان سذاجتها. ومن شأن الرُّضوخ لإغراء هذا المنطق أن يُزيِّف الوعي الجماهيري بالواقع من حوْله؛ وأن يعطِّل أولويّات التعامُل مع معضلاته؛ وأن يستدرج الجمهور إلى خنادق التأجيج المدفوع بالكراهية والعنصرية والتعصُّب؛
على نحو يخسر فيه المجتمع أقساطاً من سلامته القيمية والتزاماته المبدئية، وقد يدفعه هذا الانجراف إلى اختيارات سياسية عابثة لا مصلحة له
فيها في العاجل أو الآجل.


